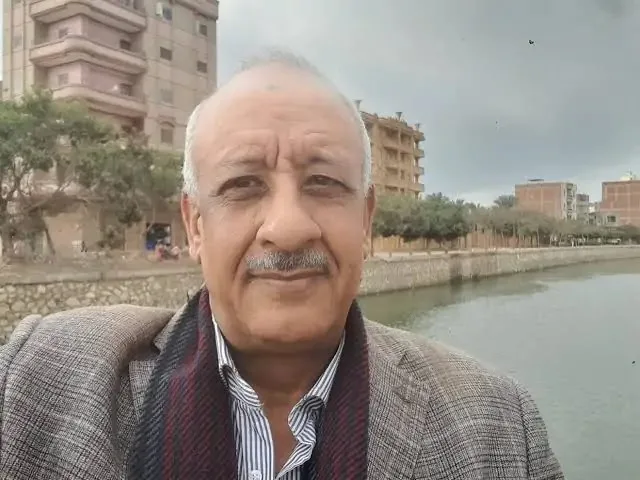
حين نتأمل المشهد الأوروبي اليوم، نجد أن ميزان القوى لا يخضع لمنطق العدد، بل لمنطق التنظيم والمشروع. المسلمون يشكلون ما يقارب 5% من سكان القارة الأوروبية، أي نحو 55 مليون إنسان، بينما لا يتجاوز عدد اليهود 1.5 مليون نسمة، أي ما يعادل 1.5% فقط. لكن على أرض الواقع، من يقود الإعلام الأوروبي؟ من يضغط على البرلمانات؟ من يفرض أجندته على السياسات الخارجية والداخلية؟
إنها الأقلية اليهودية، التي استطاعت أن تحوّل ندرتها إلى نفوذ، وقلة عددها إلى سلطة متحكمة. بينما المسلمون — وهم الأغلبية العددية — ما زالوا يعيشون كغرباء في قارة توفر لهم مناخ الحرية، لكنهم دخلوا إليها بعقلية “العبيد”: خوف من الكلمة، حب النفس، انطواء على الذات، وقناعة بحد أدنى من الحياة: “دعنا نعيش”.
والأغرب من ذلك أن المسلمين ذهبوا إلى أوروبا على أساس أنها “بلاد حرية”، لكنهم حملوا معهم إرث القمع من أوطانهم. هروبهم من أنظمة دكتاتورية لم يحررهم، بل جعلهم عبيد الخوف والقعر، خائفين من أي حركة أو كلمة قد تعيدهم إلى مصيرهم الأول.
بينما اليهود — الذين هربوا من نفس القهر والاستبداد — استطاعوا تحويل المحنة إلى قوة، والمأساة إلى مشروع، والمعاناة إلى وسيلة ضغط ونفوذ. وهنا يتجلى الفارق بين عقلية تصنع من القيد زنازين جديدة، وعقلية تحوّل السلاسل إلى سلاح.
السياسة الأوروبية ذاتها ليست محايدة. اليهود جاؤوا إلى أوروبا محمّلين بذاكرة المحرقة، فجعلوا من مأساتهم رصيدًا سياسيًا وذراع ضغط لا يُقهر. بينما المسلمون جاؤوا مثقلين بعقدة الخوف من “التطرف”، فقبلوا أن يكونوا مجرد “جاليات” بلا صوت، خاضعة للرقابة، مستسلمة للتصنيف المسبق.
اليهود صهاينة على قلب دين واحد، يعرفون أن القوة في الوحدة. أما المسلمون، فهم “شعوب وملل”، كل جماعة منشغلة بطائفتها ومذهبها، كأنهم تائهون في نفس الفُرقة التي مزقتهم في أوطانهم. هكذا صنع اليهود الفتنة، وهكذا وقعنا نحن في شباكها.
ولم يقف الأمر عند حد التشرذم الداخلي؛ بل إن الطوائف الإسلامية باتت أعداء لبعضها البعض، بعضهم يكفّر بعضًا، وبعضهم يتعاون صراحة مع اليهود ضد إخوانهم. وكأن عقيدة الولاء والبراء قد انقلبت رأسًا على عقب. فبدل أن يكون اليهود عدو الأمة الأول، صار بعض المسلمين يداً في يدهم، بينما يُستنزف دم المسلمين بأيدي إخوانهم.
الأدهى من ذلك أن الأنظمة العربية ذاتها، التي يُفترض أن تحمي العقيدة والهوية، صارت ترى في اليهود قوة ضامنة لبقائها. ثقتها في “إسرائيل” والغرب أكبر من ثقتها بالله وشعوبها، وكأن حماية العروش والمناصب مقدمة على حماية الدين والكرامة. وهذه المفارقة ليست مجرد خلل سياسي؛ بل هي خلل في العقيدة والإيمان الفعلي بالله. كيف يتحدون نصوصًا صريحة في كتاب الله تنهى عن موالاة اليهود أو الركون إليهم، ثم يتباهون بهذا التبعية وكأنها دهاء سياسي؟ أليس هذا تحديًا لله قبل أن يكون خيانة للأمة؟
السياسي الأوروبي يعرف أن المسلمين قوة كامنة، لكن بلا مشروع، فيتعامل معهم باعتبارهم “كتلة صامتة” قابلة للاحتواء، بينما يتعامل مع اليهود باعتبارهم “شريكًا في القرار”. وهنا يتجلى التناقض: كيف لــ1.5 مليون يهودي أن يقهروا 55 مليون مسلم؟
الأمر أبعد من أوروبا. نحن نتحدث عن أمة تتجاوز 2000 مليون مسلم حول العالم، لكن حضورها في السياسة العالمية يكاد يكون معدومًا. لم نسمع عن عالم مسلم بارز يقود ثورة في الذكاء الاصطناعي، أو مفكر مسلم يحصل على نوبل في الاقتصاد أو السلام، أو صانع مسلم يترك بصمته في الصناعة أو التجارة العالمية.
الأسباب واضحة: ضعف العقيدة، ضعف الإيمان بالله، الخوف على الرزق، غياب القيادة الفكرية والسياسية، والتبعية لمفاهيم غربية بدل صناعة نموذج إسلامي أصيل. المسلم الأوروبي بات يخاف من تهمة “الإسلام السياسي” أكثر من خوفه من الحساب أمام الله، فانكفأ إلى صومعته، ورضي أن يكون مجرد “مهاجر صالح” لا يطالب ولا يعترض.
إنها أزمة مشروع، وليست أزمة عدد. اليهود مشروع سياسي واقتصادي وفكري، بينما المسلمون مجرد كتل بشرية بلا مشروع، بلا أفق، بلا قيادة. ولهذا سيبقون أسرى الهامش ما لم يخرجوا من دائرة الخوف والانطواء إلى دائرة التأثير والمشاركة.
اليوم، السؤال لم يعد: “لماذا يصمت المسلمون؟” بل أصبح: هل هناك إرادة سياسية وإيمانية لنهضة المسلمين في أوروبا؟
إن لم يكن الجواب حاضرًا، فستظل الأمة تعيش موتها البطيء… وهم أحياء.
